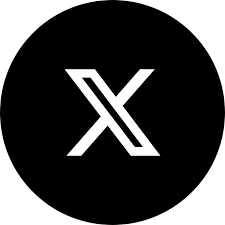صنعاء - زكريا حسان
تحاول "وردة" أن تضع طفولتها نصب عينها وهي تربي أطفالها، لتتلافى وضع صغيرتها في المكانة التي عانت منها، وأججت داخلها مشاعر الغيرة، والإحساس بالدونية عن أشقائها الذكور الذين حظوا بكل الاهتمام والحب والرعاية، وعاشت مع أخواتها الإناث على الهامش.
"وردة" واحدة من سبعة إخوة -أربع بنات وثلاثة أولاد- حرمت شقيقاتها اللتان يكبرنها من التعليم، وكادت أن تكون الثلاثة، لولا تدخل بعض أفراد أسرتها، وإقناع والديها بصعوبة من إلحاقها بالمدرسة.
ما تزال وردة تحمل الكثير من المرارة في قلبها على الرغم من مرور سنوات طويلة، وبكلمات حزينة تقول: لم نكن نسمع عبارات مديح كالتي تقال لإخوتي الذكور التي غالبًا ما يأخذهم أبي معه خلال زياراته، ويفتخر بهم وبمناقبهم أمام الناس، ويرفض أن نرافقه أنا وشقيقاتي، وكنت أتمنى أن تكون لي حرية اللعب والحركة مثلهم.
وتضيف: لا ذنب للفتاة أن تولد على هذه الهيئة ليتم الانتقاص من حقها، وتحديد أدوارها بظلم وجعلها مستسلمة للرجل منذ الطفولة، فالأخ وإن كان يصغرها بالعمر يقوم بدور الوصي والمسئول عنها.
مبررات
تقوم الثقافة المجتمعية في اليمن والبلدان العربية بإعلاء شأن الذكر، واعتباره الوريث وولي العهد، وحامل اسم الأسرة ومستقبلها، بعكس البنت التي ما يزال المجتمع ينظر لها كعورة، ويخاف أن تحمل له وصمة عار بالمستقبل، ويتباهى بالتعامل الشديد بتربيتها.
ويعد تفضيل الأسرة للذكور موروث ثقافي بحجة استمرارية النسب، وقدرة الولد على تحمل مسئولية الأسرة وحمايتها، ورعاية الوالدين في كبرهما، على الرغم أن البنت من قد تقدم الرعاية للأبوين، بينما يتملص الولد من المسئولية، وينصرف لحياته الخاصة، كما تؤكد الدكتورة رضية باصمد أستاذ علم الاجتماع المساعد، ونائبة عميد كلية الآداب بجامعة عدن لشئون خدمة المجتمع.
وترى باصمد، أن هذا الثقافة تجعل الأسرة تعطي صلاحيات مفتوحة للذكر في الاختيار والاختلاط وغيرها، بعكس الأنثى التي تقيد حقها في تقرير مصيرها حتى في التعليم والزواج.
وليس تفضيل إنجاب ابن على إنجاب ابنه انتهاكًا في حد ذاته، لكن التنميط القائم على النوع الاجتماعي لا سيما ما يُعطي الذكر فوقية على الأنثى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان "حالة سكان العالم 2020".
ويرجع التقرير أسباب التمييز في الموروث الثقافي إلى الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي والصورة النمطية التي تعتبر الرجال كاسبوا الزرق وحماة العائلة، وبالمقابل، يُنظَر إلى المرأة كمكلفة برعاية المنزل وتربية الأطفال، والمهام التي تتطلب تعليمًا بسيطًا.
وعلاوة على تلك الممارسات تلقن الفتاة أن مستقبلها متوقف في نهاية المطاف على زوجها فتشعر بالدونية أمام الفتيان، وتجعلها تخضع لهم بصور شتى، وتجبر على الانسياق وراء قيم المجتمع التي تقرر ماهية الأنثى.
سلطة مطلقة
الانكسار والضعف والتمييز الذي تعاني منه النساء في المجتمعات اليمنية سببه الرئيسي التربية الأسرية الخاطئة القائمة منذ ولادة الطفل في الأسرة، وتصنيف جنسه، والتمييز الذي يصل أحيانا إلى نوع وحجم المشاعر التي يُستقبل بها المولود، كما تقول الناشطة الحقوقية والنسوية والمدير التنفيذي لمؤسسة ألف باء بهية حسن.
وتضيف حسن: تستمر المعاملة الأبوية في التمييز من خلال الشدة والتضييق، والتزمت في تربية الأنثى، والحرية المطلقة والزهو والتفاخر بالذكور، وتكريس التفضيل القائم على العادات والتقاليد المجحفة، والرؤى الدينية المغلوطة التي تمنح الرجل كل الامتيازات والصلاحيات.
وتحدد التنشئة التي تبدأ لحظة الولادة القوالب النمطية لأدوار الجنسين، وتصنع نظام السلطة غير المنصفة التي تؤدي إلى سيطرة الرجل على المرأة، وتجعلها أكثر عرضة لتصبح ضحية للعنف الجسدي والجنسي والنفسي.
تُجحف التنشئة الاجتماعية بحق المرأة، وتقيد دورها المجتمعي، وتمكينها الاقتصادي، وتضعف قدرتها في اتخاذ القرار، وتفيد تقارير أممية أن أعمال المنزل والرعاية غير مدفوعة الأجر يحد من حصول النساء على حقوقهن، حيث يصل متوسط الوقت الذي يصرَفنه في هذه الأعمال أكثر بثلاثة أضعاف عن الرجال.
بيد أن الدكتورة باصمد لا ترى إشكالًا في توزيع الأدوار إذا كان قائمًا على مبدأ التكافؤ والقبول بين الطرفين، بحيث يسعى الرجل للعمل، وجلب المال لإسعاد الأسرة، وتقوم بالمرأة بالاهتمام بالمنزل والأبناء.
التغيير ليس مستحيلًا
تتباين المجتمعات في نوعية وحجم القيود المفروضة على الفتاة في اليمن، فالمجتمعات الريفية تحرم كثير من الفتيات من التعليم، ويتم تنشئتها لتكون زوجة وربة بيت وتساعد في أعمال الزراعة، فيما مجتمعات أخرى منحت المرأة مساحة نسبية من الحقوق والحرية.
وبحسب الناشطة بهية حسن فإن التربية الأسرية تلقي بظلالها على علاقة الأبناء بعضهم ببعض، وتعطي الذكور السلطة، والحق في التحكم، وتسيير حياة الطرف الآخر، وتنتقل السلطات والتبعية من حدود الأسرة الصغيرة إلى المجتمع، وتخلق الفجوة المجتمعية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وما يصاحبه من عنف وانتهاك لحقوق المرأة.
وتوضح أن تغيير الموروث الثقافي ليس بالأمر السهل، لكنه ليس بالمستحيل، ويتطلب نضال متواصل من النساء لاستصدار قوانين داعمة لحقها في المناصفة والتساوي بالحقوق، ليستقيم ميزان العدل المجتمعي، وتصل المرأة للمشاركة الفعلية في كافة المجالات.
وهذا ما تؤكده الدكتورة باصمد التي ترى أن التغيير يجب أن يكون من الداخل عن طريق العلم والتوعية، والاستفادة من تجارب الآخرين، وتكيفها وتقنينها بما يتناسب مع البيئة المحلية، وليس أخذ تقاليد وثقافة وعادات مختلفة، ومحاولة فرضها على مجتمع محافظ كاليمن.
وتقول: المجتمع سيتقبل التغيير الإيجابي، لكن لو كان سلبيًا فسيقابل بردة فعل عكسية، ويحدث التصادم، وكلما اجتهدنا بتوعية وتسليح الأجيال بالعلم، وتوريث ثقافة تنويرية، نكون قد عملنا أساس راسخ لمستقبل العلاقة بين الجنسين.
.png)